بين الوحي والعقل لا خصومة بل تكامل رد على مقال الدكتور صلاح سالم: “بين الأنطولوجيا القرآنية والإبستيمولوجيا السنية”
بقلم: د. محمد بن أحمد ابن غنيم المرواني

ارسل لي صديقي المهندس وائل محمود من مصر نسخة من مقال تم نشره للدكتور صلاح سالم بعنوان “بين الأنطولوجيا القرآنية والإبستيمولوجيا السنية” في جريدة “الشرق الأوسط” بتاريخ 28 يوليو 2024، وقد طُرح فيه تصورٌ نقدي للعقل الإسلامي السنّي، وتحديدًا لعلاقته بالإيمان والعمل، وبالأنطولوجيا والإبستيمولوجيا، كما خُتم بدعوة ضمنية إلى تبنّي أدوات حداثية لفهم الدين وتفعيله في الواقع، و طلب مني صديقي إعطاء رأيي في هذا المقال.
فتوقفت باديء الامر عند المفاهيم و المصطلحات الفلسفية الكبرى التي ذكرها الدكتور .ثم اعدت القرأة عدة مرات لاتبين قصد الكاتب و قمت بالبحث و التدقيق محاولا فهم قصده .
فكنت أمام مقال فلسفي متطور يفلسف الفلسفة في اسلوب طرحه، و يناقش مفاهيم و مباديء شرعية بأسلوب علمي فلسفي مختلف ،
فتوقفت مرة أخرى فوجدتني لست بفيلسوف و لا فقيه في الدين .
فرجعت خطوة الى الوراء و تفكرت . . . هل علي الرد و التعقيب و إعطاء اخي وائل محمود رأيي في المقال ، أم اعتذر و انسحب ،؟
و لكن الانسحاب ليس من طبعي فقررت الاجتهاد و الاقدام و إعطاء رأيي الشخصي فإن أصبت فلي اجران و ان أخطأت فلي أجر.
و تجب الاشادة بانني قد قرأت المقال بتقدير لصاحبه، فهو كاتب مثقف ومجتهد في طرحه، لكن وجدت ان ما تضمنه من إسقاطات فلسفية على الموروث الإسلامي بحاجة إلى مراجعة هادئة ومنصفة، لا رفض فيها ولا خصومة، وإنما محاولة لتصويب المسار، والإسهام في النقاش من داخل البيت الشرعي لا من خارجه.
أولًا: الإسلام جمع بين الإيمان والعمل
افتتح الكاتب مقاله بفكرة أن العقل الجمعي الإسلامي يركز على ما ينبغي الإيمان به لا ما ينبغي فعله، وأن المساءلة في الدين منصبة على صحة الاعتقاد لا على جودة السلوك. وهذه دعوى تُخالف ظاهر النصوص القرآنية والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم.
فالإيمان في القرآن مقرون بالعمل الصالح في مئات المواضع، ولم يُقدَّم كغاية نظرية منفصلة عن السلوك، بل كمنظومة متكاملة تثمر أثرًا في حياة الفرد والمجتمع. قال تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا” [الكهف: 107].
وقد قال النبي ﷺ: “الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان” [رواه مسلم]. فالإيمان في التصور النبوي ليس مجرد قناعة عقلية، بل عمل أخلاقي وسلوك يومي.
ثانيًا: الأنطولوجيا القرآنية تأسيس للواقع لا انسحاب منه
اعتبر المقال أن الأنطولوجيا القرآنية (أي تصورات الوجود والغاية) تهيمن على عقل المسلم وتبعده عن الواقع. والحق أن هذه الأنطولوجيا ليست تجريدًا فلسفيًا، بل هي تأسيس واقعي عملي للوجود الإنساني: لماذا خُلِقنا؟ إلى أين نمضي؟ ما غاية العمل؟ وما حدود العقل؟
القرآن لا يطرح الأنطولوجيا كملجأ روحي، بل كإطار لفهم الذات والآخر والعالم، وبناء سلوك مسؤول يُنتج التزكية والعمارة معًا.
و من الأدلة على تفعيل العقل و التعامل مع الواقع في النهج الاسلامي حديث الرسول صلى الله عليه و سلم ( انتم اعلم بشؤون دنياكم ) و كان في امور الزراعة وقد قال النبي ﷺ: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” [رواه أحمد]. وهذه أعظم ترجمة للأنطولوجيا الأخلاقية النبوية.
ثالثًا: المعرفة في الإسلام ليست معطّلة بل مؤصَّلة
رأى الكاتب أن الإبستيمولوجيا (نظرية المعرفة) مغيّبة في التراث السني لصالح قضايا الكينونة، وهو طرح لا يُنصف العلوم الإسلامية.
فأصول الفقه، وعلم المقاصد، وأدوات الاجتهاد، والتعامل مع النصوص، كلها مظاهر واضحة لحضور عقل منهجي منضبط، يُنتج المعرفة انطلاقًا من الوحي دون أن يُعطّل العقل.
بل إن مدارس السنّة الكبرى (كمدرسة الشافعي وابن رشد – رغم بعض التحفظات على رؤيته الفلسفية- والشاطبي) تمثّل محاولات مبكرة لتأسيس إبستيمولوجيا إسلامية لها أصولها ومنهجها.
رابعًا: الإسلام لم يكتفِ بإجازة الاجتهاد بل كافأ عليه
من أعظم الأدلة على احتضان الإسلام للاجتهاد وتشجيعه عليه، ما رواه البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال: “إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد ثم أخطأ فله أجر”.
وهذا الحديث يثبت أن الإسلام لا يقر فقط مبدأ الاجتهاد، بل يُثيب عليه حتى في حال الخطأ، بشرط حسن النية وسلامة المنهج. فالخطأ في الاجتهاد لم يُقابل بالتجريم أو التعنيف، بل اعتُبر من طبيعة البشر ما دام في حدود السعي الصادق.
ووفق هذا الفهم، فإن الاجتهاد في الفقه كما في الطب لا يصح أن يُمارسه إلا من يمتلك أدواته. وكما لا يُفتى في شؤون الجراحة والتشخيص إلا من مارس الطب، فلا يُفتى في الشريعة إلا من رَسَخ في علومها. وهذه رؤية شخصية أجدها منضبطة ومنصفة: الاجتهاد ليس حقًا عامًا، بل أهلية علمية مخصوصة.
خامسًا: مكانة الصحابة ليست عصمة، بل عدالة وسَبق
ذهب المقال إلى أن العقل السني منح الصحابة عصمة مفهومية، وهذا غير دقيق. فالصحابة عند جمهور أهل السنة ليسوا معصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، وقد وقع منهم الخطأ وأُقيم على بعضهم الحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن أشهر الأدلة: حديث ماعز بن مالك الأسلمي، الذي جاء إلى النبي ﷺ معترفًا بالزنا، فأقام عليه الحد بعد التثبت. [رواه البخاري ومسلم]. ولو كان الصحابة معصومين لما جاز وقوع مثل هذا منهم.
ومع ذلك، فإن عدالتهم وفضلهم لا يُنكر، لأنهم سبقوا إلى الإيمان، وجاهدوا مع النبي ﷺ، ونقلوا الدين للأمة بأمانة. قال تعالى: “وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ… رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ” [التوبة: 100].
قال الإمام أحمد: “من الطعن في الصحابة ترك السنة”، أي أن بناء المعرفة الإسلامية يفترض الثقة بمن نَقَلها، لا باعتبارهم فوق الخطأ، بل لثبوت عدالتهم في الجملة.
ومع ذلك، فإن علم الرجال الذي اختص بتوثيق الرواة، وتحقيق عدالتهم وضبطهم، هو من أدق العلوم البحثية في التراث الإسلامي، بل في تاريخ العلوم كلها. فليس ثمّة علمٌ اشترط هذا الكم من الضوابط الدقيقة، والتثبت المنهجي، والنقد الداخلي والخارجي للسند والمتن كما فعل علم الرجال.
وهذا يؤكد أن الفقه السني لم يُقدّم الصحابة وسائر الرواة على أنهم أنصاف آلهة معصومين، بل بشر يُوزنون بميزان التحقيق، وفق قواعد منهجية صارمة، وهو ما يثبت بدوره أن البحثية والعقل الاجتهادي جزء أصيل من البناء الفقهي السنّي، لا خصم له ولا عدو.
سادسًا: الحكمة تُكتسب، وليست وحيًا خفيًا
انتقد الكاتب ما رآه خلطًا في التراث بين العلم والحكمة، واعتبر أن الحكمة تُعامل كنبوة لا تُكتسب. والحقيقة أن القرآن ذاته بيّن أن الحكمة تُؤتى لمن يسعى إليها، وأنها فضل من الله يرزقه من يشاء.
وقال تعالى
( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ)
(البقرة: 151)
وقد صح عن النبي ﷺ قوله: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلّطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها» [رواه البخاري ومسلم].
فهذه الاية وهذا الحديث الشريف يدلان دلالة واضحة على أن الحكمة شيء يُؤتى ويُتعلَّم ويُعلَّم، وليست حكرًا على الإلهام أو الفطرة الخاصة. بل إن تعلّم الحكمة وتعليمها من أعظم أسباب الغبطة الشرعية، مما يؤكد أن الحكمة يمكن اكتسابها، ونقلها، وأنها ليست قاصرة على طائفة مخصوصة.
الحكمة في الفهم السلفي هي: الفقه في الدين، والبصيرة في الواقع، وحسن التنزيل. وهي تُكتسب بالتعلم والمجاهدة، لا بالإلهام المعزول.
سابعًا: الفقه السني قابل للتجديد والاجتهاد بضوابطه
انتهى المقال إلى أن الفقه السني محصور داخل دائرة مغلقة، لا تتفاعل مع الحداثة ولا مع الواقع. وهنا نحتاج إلى تفريق ضروري:
نعم، بعض الممارسات الفقهية في عصور الانحطاط جمدت الاجتهاد.
لكن المنهج السني نفسه لا يمنع الاجتهاد، بل يشترطه ويؤصّله.
وقد شهد العصر الحديث محاولات تجديدية كبرى من داخل المدرسة السنية: من محمد عبده، إلى ابن عاشور، إلى الشاطبي، إلى أبو زهرة، إلى المعاصرين الذين مزجوا بين النص والمقاصد والواقع.
وقد عبّر عن هذا الفهم المنفتح شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي حين قال لزملائه العلماء: “هذه القوانين كلها أمامكم، اختاروا منها ما شئتم، ودعوا لي مهمة إيجاد الدليل الشرعي”، في إشارة واضحة إلى سعة الشريعة، ومرونة الاجتهاد المؤصّل، وقدرتها على استيعاب النظم الحديثة دون الخروج عن أصولها.
ثامنًا: حسن الخلق جزء من جوهر الدين لا هوامشه
أغفل المقال أن الخلق والمعاملة الحسنة هما جوهر الدين ومرآته في الواقع. وقد صح عن النبي ﷺ قوله: “أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا” [رواه الترمذي]. وقال أيضًا: “إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم” [رواه أبو داود].
إن السلوك في الإسلام ليس ترفًا أخلاقيًا، بل هو الامتداد العملي للإيمان، وهو ما يُترجم الأنطولوجيا إلى إبستيمولوجيا حية.
خاتمة: بين الوحي والعقل تكامل لا خصومة
نُقدّر لصاحب المقال حرصه على إحياء العقل في التفكير الديني، ولكن العقل لا يُبعث بإلغاء الوحي، ولا تُبنى المعرفة بإسقاط التصورات الفلسفية الغربية على التراث الإسلامي.
إن العقل في الإسلام ليس نقيضًا للنقل، بل شريك له. والفقه ليس مغلقًا، بل يتجدد حين نحسن فهم أدواته. والأنطولوجيا القرآنية ليست انسحابًا، بل انخراطًا عميقًا في سؤال المعنى.
نحتاج إلى قراءة تراثنا بعيون زمننا، في أمور المتغيرات الزمنية لا أن نعيد كتابته بمنطق غيره.
ولعل ذلك أصدق للعلم، وأنفع للتجديد الفقهي بما ينفع الناس في امور معاشهم.


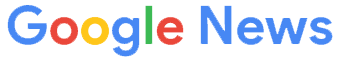





بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك سعادة الأخ العزيز الشيخ الدكتور محمد بن أحمد بن غنيم المرواني الجهني
أنا هنا أشيد بجمال الأسلوب وجمال الطرح وروعة الحوار
وعمق اللغة وسلاسة المفردات وهذا لا يستغرب من شخصكم الكريم كما عهدناكم تسبرون أغوار اللغة وتجيدون فن الحوار الراقي وتشبعون الموضوع من خلال نظرتكم الثاقبة ورؤيتكم الصائبه إما عن تفاصيل هذا الموضوع الذي أتت لغته عالية الذبذبات وكان متعمق الفلسفه ويناقش جانب من المسار الديني لست مؤهل للخوض فيه ولكن كما أسلفت اعجبت بأسلوب الحوار الهادئ والهادف بين الكاتبين الكبيرين
تحياتي وتقديري لكم ودمتم بخير .