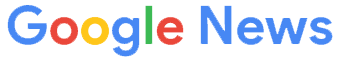اقام نادي مكة الثقافي الأدبي لقاء ثقافيا بعنوان:” تجربتي مع التلقي والتأويل” عبر منصة “زووم” قدمها الأستاذ حامد بن عقيل وأدار الحوار الأستاذة رغد القرشي التي رحبت في البداية بالحضور باسم رئيس النادي الأدبي الأستاذ الدكتور: حامد بن صالح الربيعي وقدمت شكرها للدكتور حامد والدكتور سامي الثقفي منسق برامج النادي على مجهوداتهم في إقامة مثل هذه اللقاءات التي تثري الساحة الثقافية.
وأضافت قائلة لقاؤنا اليوم متوّجٌ باستضافة الأستاذ القدير حامد بن عبدالهادي بن عقيل؛ الشاعر والناقد والروائيّ السعوديّ.. هذا اللقاء المحمّل بتجربة غنيّة لضيفنا في مجال النقد الأدبيّ.. وما ارتضاه في الوصول إلى نظريات التلقي وآفاق التأويل..
وأضافت قائلة: آمل أن تأخذكم تجربة ضيفنا بالفلسفة الكامنة وراء محطاتها، إلى موازاة الرؤى والتجارب بملتزمات التلقي الإيجابيّ تجاه المدخلات الهائلة التي نتعرّض لها ونحن بنو الثورة المعلوماتية والرقميّة.
وتركت الحديث للضيف الذي تقدّم بالشكر إلى نادي مكة الأدبي ممثلاً في رئيسه الأستاذ دكتور حامد بن صالح الربيعي، وأعضاء مجلس إدارته، على الدعوة الكريمة، ثم تحدث عن أسباب توجهه ناحية الاشتغال بالنقد الأدبي واول محاولاته النقدية في جسد الثقافة، وأضاف كنتُ على صلة دائمة بنتاج النقاد البارزين في الجيل السابق لجيلنا، نحن شعراء وسرّاد جيل مطلع الألفية الثالثة، ومن خلال مجلات التوباد وقوافل وعلامات في النقد وغيرها من المجلات المحلية كنتُ أشاهد نتاجاً نقدياً لسعد البازعي وسعيد السريحي وعالي القرشي رحمه الله ومحمد ربيع الغامدي ومعجب الزهراني ونورة القحطاني، وغيرهم من نقاد الجيل السابق لنا، وهو النتاج النقدي الذي لم يُخلص لدراسة النصوص، بل عمد وبشكل دائم وفيما يشبه التواطؤ، على استخدام النصوص وليس نقدها،
وأضاف مع مطلع هذه الألفية وأنا أحاول الاشتغال على تعزيز أدوات التلقي لدى القارئ العربي الذي تستهدفه النصوص، ذلك أن النقد الأكاديمي يبقى في الغالب رهين ساحات السجال الجامعي والملتقيات الخاصة بالنُّخب الأكاديمية، وهو إلى ذلك ينحو، باتجاه التنظير أكثر مما يسعى لتقديم تطبيقات إجرائية على نصوص شعرية أو سردية عربية يمكن أن تساهم في مدّ القراء العرب بآليات تلقٍ نقدية حديثة، كما أنه، أعني النقد الأكاديمي، لا يسهم في سدّ فراغ التطبيق النقدي، الفراغ الذي كرّستْهُ الجامعاتُ ذاتُها بإصرارها على تدريس علوم البلاغة العربية وكأنها إرثٌ مقدّس، وهو الإصرار الذي، لا يفسّر انحياز الجامعات في العالم العربي إليه، إلا أربعة أسباب كما أعتقد؛ أولها أن القائمين على إقرار المناهج فيها يربطون بين البلاغة العربية وعلومها وبين القرآن الكريم وعلومه، وبشكل أقل بينها وبين الشعر العربي القديم، فجعل هذا الأمر البلاغة جزءاً من إرثٍ مقدّس حتى وإن لم يكن ذلك الإرث البلاغي فاعلاً، وثانيها فقر بعض أساتذة الجامعات، إضافة إلى كسلهم البحثي، فيما يتعلق بالاتجاهات النقدية اللسانية، فمثل هذه الاتجاهات كانتْ، وستكون على الدوام، بالنسبة إلى بعض الأكاديميين في العالم العربي عِلماً مجهولاً، ولبعضهم الآخر مجرد مشروع خاص،
ويضف الأستاذ حامد لعل هناك أسباباً أخرى لتوجّهي ناحية النقد، منها شعوري العميق بالامتنان لكتّاب بعض النصوص السردية أو الشعرية الحديثة، تلك التي تُتْركُ دون التفاتة حقيقية إليها وتحليلها، بل ووجوب جعلها نماذج ممثلة للمرحلة التي أُنتجتْ فيها، كتّابٌ رسوليون بدون النقد لا يمكن أن يُقال لهم شكراً على ما قدمتم من نصوصٍ إبداعية رفيعة، فحين يذوي النقد تتشابه على القراء النصوص، ويسهل توجيههم من قبل الجوائز الأدبية أو من قبل الشلل الصحفية، أو كتّاب القراءات النقدية العابرة التي تشرح وتختزل وتقدّم وتروّج فقط لأن كاتبها بحاجة إلى ملءِ فراغ زاويته الأسبوعية أو الشهرية، وهنا يختلط الحابل بالنابل، والجيّد بالرديء، ولعل هذا السبب، أعني شعوري العميق بالامتنان لكتّاب الأدب الرفيع والمميز هو ما جعلني ألتزم بألا يكون من دوافع كتابتي حول نص أدبي معرفتي بكاتبه، فقد كتبتُ عن نصوص كثيرة لم ألتق بكتابها أو أتواصل معهم مطلقاً، وكتبتُ عن نصوص أنتجها مبدعون ربما لم يُسمع بهم على نطاق واسع، بل بقي النص هو جواز المرور الوحيد، مجرداً من المعرفة بكاتبه، ومن شللية باتت أشبه بتقليد كتابي في زمن ما، ومجرداً من تأثيرات التسويق الإعلامي الاستهلاكي، أو سطوة الجوائز الأدبية في اختيار النصوص التي أتناولها. غير أن معرفتي بالكاتب، أو حصول العمل الأدبي على جائزة، أو التكريس الإعلامي، لا تمنعني هذه الأسباب أو أياً منها من تناول عمل أدبي إن وجدتُ فيه ما يستحق الدراسة.
ويستطرد قائلا: كانت تجاربي النقدية الأولى بدءاً من نهاية عام 2001 وحتى 2003، عبارة عن مقالات نقدية ومقاربات نشرتها عبر المنتديات الإلكترونية التي كانت رائجة في ذلك الوقت، ثم جاء كتابي الأول فقه الفوضى، ومنه استمر مشروعي النقدي. المشروع القائم على فكرة التطبيقات النقدية، لهذا جرّبت التوجه إلى نماذج من النصوص، الشعرية أو السردية، المتصفة بكون أي منها أثراً مفتوحاً يمكن من خلال دراسته أن تتطور آليات القراءة والكتابة لدى الكتاب والمتلقين العرب. لدي حتى الآن خمسة كتب نقدية، وجميعها تطبيقات سيميائية وتوظيف لنظريات التلقي في دراسة نصوص مختارة لكتاب سعوديين أو لكتّاب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو لكتاب من بعض دول الوطن العربي.
وأضاف : إلا أن توقفي عن الكتابة والنشر منذ نهاية العام 2010 وحتى بداية العام 2022، لم يمنعني من إعادة النظر في مشروعي النقدي، بوعي تام في أن هناك خللاً في الاشتغال السيميائي الذي مارسته،
ويختم حديثه بالقول : بقيتِ الإشارة إلى أهمية التأويل السيميائي، فحين نحدّ النص الأدبي في علاقته مع الفن بحدود النصوص الأدبية المفتوحة التي تقاوم الزمن بحسب قدرتها على مقاومة النسيان من خلال تعدد معانيها، فإننا نتعامل مع نص ينتج معنى جديدا كلما تناوله قارئ إيجابي جديد. ومن طبيعة لغة هذه النصوص أن تكون إيحائيةً رمزية، ما يجعل دراسة ومَنْهَجَة التأويل أمراً مُلحّاً للتعامل مع مدلولات اللغة داخل النّص، وهذا ما يعطي لاستعمال النّص الأدبي منهجية لا تذهب بتعدد النّص بعيداً عن هدفه، فإن: “الشيء الوحيد الذي يمكن لأيٍّ كان أن يفعله بالنّص هو استعماله” كما يرى رورتي، وسبب ذلك يرجع إلى أهمية أن نقول من خلال النّص أشياءَ ذاتِ أهميّة، إذ: “علينا استعمال النصوص، تماماً كما نستعمل معالجة النصوص، جاهدين، من خلال ذلك، لقول أشياء ذات أهميّة”.
بعد ذلك فتحت مديرة اللقاء المجال لمداخلات الحضور والتي دارت حول الفرق بين الهرمنيوطيقا والتأويل، واقتراح انشاء جمعية لتناول النظريات التأويلية والنقد التطبيقي.